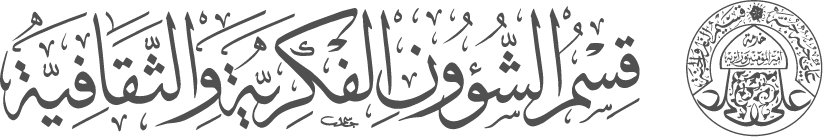الصغار لا تتحمّل ذنوب الكبار
كان يومٌاً حارّاً.. من أيام حزيران 2015.. إذ الشمس تغيّر لون الثياب وسموم الصحراء كاللهيب تشوي الوجوه.. تقدّمنا من جرف النصر نحو معبر (بزيبز) لاستقبال العوائل النازحة من الرمادي بعد سقوطها بيد داعش وقد صرّح محافظ بابل باستقبال النساء والاطفال والرجال المسنّين فقط ورفض استقبال الشباب قائلاً.. عليهم أن يحملوا السلاح دفاعاً عن ارضهم وعرضهم؛ فرفضت بعض العائلات الدخول للمحافظة من دون الشباب وبقيت عالقة هناك.
كنت انظر إلى السيارات القادمة عبر الصحراء وهي تحمل العائلات وبينهم اعداد كبيرة من الشباب فأخذت اتساءل مادام هؤلاء الشباب بأتم الصحة والعافية وبكل قواهم البدنيّة لماذا لا يدافعون عن عرضهم وارضهم؟
اخذت اجول ببصري بين تلك الاعداد الكبيرة العالقة هناك، فوقع نظري على امرأة محتشمة بحجابها حزينة، منكسرة، مستكينة، تلفُّ طفلاً صغيراً وتظلل له بعباءتها من حرارة الشمس، فسالتها عن والده؛ فأشارت نحو الرمادي ولم تنطق ببنت شفة.
فقلت في نفسي: انّ أباه بقي هناك، أي أنه ما يزال مع الدواعش، فاشتعل قلبي غيضاً وبدأت أكلم نفسي وقلت: يقاتلوننا ونحن نستقبل عائلاتهم ونحمي ابناءهم، فلو وقع ولدي الصغير في يدي ذلك الداعشي لذبحه وقال: «ربي لا تدع للكافرين على الارض ديّارا»، لأنه قد كفرني ويلحق بذلك عنده كفر ولدي تبعاً لي، ولو إن هذا الطفل تربّى بحجر والده وتغذّى من افكاره المسمومة لشبّ على تكفيرنا واباحة دمائنا.. فقلت: لها اكشفي عنه.. فكشفت عن طفل صغير ملفوف بخرقة بيضاء.. تنطق عيناه بالبراءة وهو يلوج برقبته وقد اخرج لسانه من شدة الحر.. فتذكرت الامام الحسين (عليه السلام) في العاشر من محرم عندما حمل طفله الرضيع وقال لأعدائه: ((اسقوه ماء فقد جفّ ثديا امه من شدة العطش، وإن كان هناك ذنب للكبار فما ذنب هذا الصغير))، فاستعبرت باكياً واسرعت إلى السيارة وجلبت قنينة ماء وقلت لامه: خُذي واسقيه لعلّه عطشان، وتليت قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1].